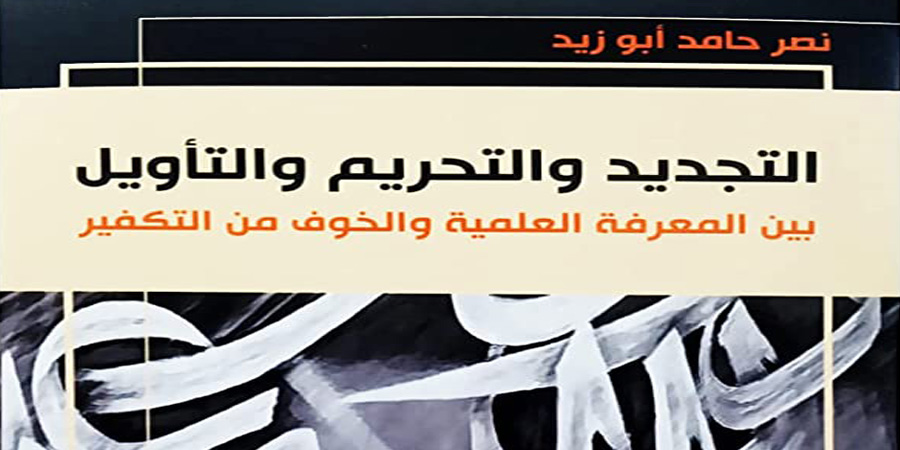ملخص كتاب التجديد والتحريم والتأويل
المصدر : مجتمع الاكاديميه بوست
الملخص
أهميّة تجديد الخطاب الديني
تظهر الحاجة إلى التجديد عندما تتأزّم الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. فتدخل الأمّة في حالةٍ من الركود واجترار إنجازات وانتصارات الماضي هرباً من انكسارات وخيبات الحاضر. والتجديد عمليّة تواصلٍ خلّاقٍ بين الماضي والحاضر. فهو خروجٌ من التقليد الأعمى وإعادة إنتاج الماضي باسم الأصالة، وتحررٌ من التبعيّة الفكريّة للغرب باسم التطور.
التجديد في ضوء المتغيّرات الاجتماعيّة
ظهرت في القرن التاسع عشر، واستقرت في القرن العشرين، قناعةٌ بأنّ مجتمعاتنا دخلت مرحلة الحداثة بسبب التغيّر الكبير الذي حدث في البنية السياسيّة وبدايات تشكّل الدولة الحديثة. ولكنّ الهزيمة المدوّيّة في حرب عام 1967 أظهرت أنّ مجتمعاتنا ما تزال مجتمعاتٍ تقليديّةٍ. وأنّ آليّات اتخاذ القرارات آليّاتٌ غير مؤسّساتيّةٍ تابعةٌ لرغبة القائد. استوجب ذلك إعادة قراءة التراث، ليس بهدف التقليد وإعادة الإحياء، بل بهدف النقد واستخلاص النتائج وفق رؤيةٍ حداثيّةٍ.
تقوم الجماعات السياسيّة وأنظمة الحكم المستبدّة بمحاولة توظيف الدين لتحقيق غاياتٍ شخصيةٍ أو حزبيةٍ مستغلّةً تدخّل الدين في كلّ مجالات الحياة. فتعمل على السيطرة على الشعوب من خلال التحالف مع أو الضغط على رجال الدين. يتولّد الخطر هنا من أن يؤدي خلط الدين بالسلطة إلى تحميل الدين مسؤوليّة الظلم السياسيّ. كما حدث سابقاً عندما سببت ممارسات الكنيسة الضرر للدين المسيحيّ في أوروبا. لذلك يجب أن يدخل التنوير وإعمال العقل في كلّ المسائل الدينيّة المحرّم على العقل الغوص فيها من أجل تحريرها من سيطرة الفقهاء وهدم الجدار الذي يحاولون تشييده بين العامّة والخاصّة.
تتشارك الحركات الأصوليّة الفزع من التجديد و التأويل العصريّ للإسلام فيما بينها حتى وان اختلفت مذاهبها. وتعتبر أنّ الآراء التي طرحها السلف صائبةً بسبب قربهم التاريخيّ من العصر الذهبيّ للإسلام، ولأنهم أكثر تقوى من المعاصرين. فأصبحت كلمة التأويل والتفكير النقديّ عندهم رمزاً لمحاولات هدم الإسلام، خاصّةً وأنها ارتبطت بصراعاتٍ سياسيّةٍ تاريخيّةٍ. واعتبرت محاولةً لإرضاء الغرب دون التمييز بين الغرب السياسيّ الذي تحكمه العلاقات والمصالح والغرب الحضاريّ بما يشمله من فكرٍ وفلسفةٍ وفنون. أدى ذلك إلى المزيد من الانغلاق والتقوقع على الذّات ورفض كلّ محاولةٍ لقراءةٍ عصريّةٍ للدين تنطلق من المتغيرات الاجتماعية والثقافيّة.
التجديد في مواجهة التحديات الخارجيّة
تحاول العولمة صنع دينٍ جديدٍ قائمٍ على قوانين السوق والعمل. وهو دينٌ لا يُقهَر ولا يُعطي وعوداً بالرحمة والعدالة والانتقام من الظلم. لذلك فمن الطبيعيّ أن تقاوم كافة المجتمعات- بما فيها المجتمعات التي صنعت الحداثة- هذا الدين وقوانينه القاسية التي صنعها الأقوياء للسيطرة على المجتمع. وقد تمكّن الدين الجديد من احتواء تأثير الأسلحة القديمة المستخدمة في مواجهته والمتمثّلة في الحفاظ على التراث. وعرف كيف يوظفها جيداً في دعوى مكافحة الإرهاب وصراع الحضارات، بحجّة الحفاظ على السلم العالميّ وحريّة حركة السوق. لذلك ينبغي استخدام أسلحةٍ جديدةٍ تكشف وحشيّته، وتساهم ببناء حضارةٍ قادرةٍ على استيعاب الاختلافات والتناقضات عن طريق فتح أبواب العلم والمعرفة والحريّة.
ساهمت مشاريع الحداثة وإعادة التأويل بفصلها بين الإسلام والمسلمين بتمجيد الماضي في مقابل إدانة الحاضر. ولم يتمّ نقد الماضي إلّا في مرحلة الانشطار والتشظي الفكري والثقافي. وساهم ظهور التعليم المدنيّ بدل المدارس الدينيّة المنتشرة حينها في توسيع الفجوة الثقافيّة بين خرجيّ المدرستين. تزامن هذا مع انتشار خطاب الاستشراق الذي يركز على أنّ الإسلام هو المشكلة والعقبة التي تفصل العرب عن التطور والحداثة. مما أدى إلى ظهور خطابٍ دفاعيٍ لتبرئة الإسلام من تخلّف المسلمين. وهكذا ظهر تيار الإصلاح الدينيّ الذي تحالف أحيانا مع السلطة، وهاجمها أحيانا بحسب اختلاف وتوافق المصالح.
التجديد يحصّن الدين من التوظيف السياسيّ
إنّ محاولة نسب التخلّف الاجتماعيّ إلى مشكلةٍ في بنية العقل الإسلاميّ بمعزلٍ عن الظروف الاجتماعيّة والتطورات التاريخيّة تفتقر إلى الصحّة والعقلانيّة. لأنّ السبب الحقيقي يكمن في تفشي الجهل والظلم الاجتماعي والقمع السياسي. لذلك يرى نصر حامد أبو زيد أنه يجب علينا، من أجل نظرةٍ نقديّةٍ متوازنةٍ ونافعة، تأمّل التاريخ الإسلاميّ بوصفه تاريخ المسلمين بوصفهم بشراً وليس تاريخاً مقدساً. كما لا ينبغي فصل الإسلام عن المسلمين لأنّ هذا الفصل يؤدي إلى رسم صورةٍ طوباويّةٍ لدينٍ مثاليٍّ لا يتأثّر بالمتغيّرات الاجتماعيّة.
يمثّل التحليل النقديّ ضرورةً لا بديل عنها لفهم الدين بوصفه خطاباً إنسانيّاً ناتجاً عن البشر أنفسهم دون المساس بقدسيّة المصدر. ونلاحظ تبدّل وتطوّر هذا الخطاب بوضوحٍ وتفاعله مع المتغيّرات خلال مراحل التأسيس الأولى. لذلك فالخطاب القرآنيّ هو خطابٌ حيٌ متفاعلٌ يتطلّب دائماً إعادة قراءةٍ وتأويل من جيلٍ إلى آخر. يجب أن تتم هذه القراءة دون إغفال تأثير العوامل السياسيّة مثل الظلم الاجتماعيّ والقضايا التي تتعلّق بالصراع بين الطبقات. وتميّز هذه القراءة للعوامل السياسيّة بين التواصل الطبيعي وعلاقات التفاعل الحتميّة، وبين محاولات استغلال الدين وتوظيفه سياسياً.
- من هم المعتزلة وما هي مبادئهم؟
- ملخص كتاب اللاهوت العربي وأصول العنف الديني ل يوسف زيدان
- فلسفة التنوير وتفكيك المقدس
- ملخص كتاب الإرهاب ل فرج فودة
الفن وخطاب التحريم
نستطيع من خلال تحليل الخطاب الدينيّ التعرّف على المناخ الفكريّ العام. فالخطاب الدينيّ، بوصفه جزءاً من الخطاب الثقافي، يزدهر عندما يكون المجتمع متحرراً ومنفتحاً وإنسانيّاً. ويسوده التعصّب وعداء الآخر عندما يختنق المناخ العام.
لماذا يسبب الفنّ فزعاً لخطاب التحريم؟
الفنّ كمثالٍ على تأثر تحليل الخطاب الديني بالمناخ الفكري العام، هو ممارسة أقصى درجات الحريّة. حيث يتحرر الإنسان من خلال الفنّ من قيود الفكر واللّغة والجسد، ويبني بواسطته عالمه الخاص. لذلك يكره المتشددون- تشدّداً دينياً كان أم اجتماعيّاً- الفنّ، لأنهم يخلطون ما هو معياريٌّ بما هو فنيٌّ. فهم يسعون، بسبب فزعهم من الحريّة، إلى منع التغيير والحفاظ على اللحظة التاريخيّة والسياسيّة بهدف جعلها أبديّةً. فيتحدثون عن ضوابط ومعايير الحريّة قبل أن تبدأ الممارسة. وهو ما يعاكس الروح الأساسيّة للفنّ الذي يسعى، من خلال الغوص في آفاقٍ مجهولةٍ، لكسر وتأسيس معايير جديدةً تُكسر بدورها في تجاوبٍ مع التقدم العلمي والفكري.
هل تحرّم الأديان الفنّ؟
يظهر ارتباطٌ عضويٌّ واضحٌ بين الدين والفن. لدرجةٍ لا يتصور معها دينٌ بلا فن. يتجلى هذا الارتباط بوضوحٍ في الصور والأيقونات في المسيحيّة، وصيغ الأدعية والصلوات ذات الصياغة الشعريّة الواضحة في كلّ الأديان، فضلاً عن الموسيقى المصاحبة للصلوات في الكنائس والترتيل في قراءة القرآن. بالإضافة إلى تغلغل الفنّ المعماريّ في التصميم الداخلي والخارجي للمساجد والكنائس.
كان الإسلام قد حطّم الأصنام في بداياته حرصاً على التوحيد النقيّ الخالي من شبهة الشرك. لكنّ تحريمها ليس تحريماً أبدياً لفن النحت والتصوير، بدليل أنّ المسلمين لم يحطموا التماثيل في البلدان المفتوحة. فهو تحريمٌ نابعٌ من إدراك متغيرات التاريخ. وازدهر فنّ الموسيقى والغناء في الفضاءات الإسلاميّة. فترتيل القرآن وتجويده هو فنٌ موسيقيٌّ بامتياز. فالإسلام أدرك أنّ الفنّ حاجةٌ إنسانيّةٌ لا يمكن الاستغناء عنها. ويمتلئ القرآن بالأدوات الفنيّة من تصويرٍ وعرضٍ وتخييل. فهو نصٌ أدبيٌ بامتياز انبهر به العرب قبل التشريع والنبوءات. فطبيعته البلاغيّة هي التي دفعت الكثيرين منهم إلى الإيمان به أو الإقرار له بالتمييز والزعم، في محاولة تفسير تفوّقه، بأنه سحرٌ مبينٌ.
أحدث الإسلام تطوراً جديداً في فهم ظاهرة الشعر التي كانت قبل الإسلام مرتبطةً بتصوّر أنّ الشعراء يتلقون الوحي من الجن. تطلّب ذلك التمييز بين مفهوم النبوّة وظاهرة الشعر. فإن كان الشعر وحياً من الجنّ فإنّ القرآن وحيٌ من الملائكة دون الاستغناء عن الحاجة للشعر في الإسلام. من هنا نرى أنّ تحريم الشعر هو تحريمٌ أيديولوجيٌّ بعيدٌ عن الدين. فالشعر بقي موجوداً في عصر النبي وازدهر بعده أيضاً في بلاط الخلفاء. لذلك فإنّ قضية تحريم الفن هي قضية تحريم الحريّة الاجتماعيّة بحجّة الرقابة وحماية الأخلاق. وهو ما يؤمّن مصالح السلطتين السياسيّة والدينيّة في السيطرة على المجتمع ويتفقا عليه بصور مختلفة يعبر عنها كل منهما بأدواته.
جذور إشكاليّة تأويل القرآن
وردت كلمة التأويل في القرآن أكثر من كلمة التفسير التي غالباً ما تأخذ معنى تفسير معاني الكلمات المفردة في مقابل تفسير القصد العام في كلمة التأويل. فالتفسير تمهيدٌ للتأويل. ومع ذلك فقد اتخذت لفظة التأويل معنىً سلبياً في وجدان الإنسان العربيّ وفضّل عليها لفظة التفسير. فاتخذ التأويل تدريجياً- مع التطور الاجتماعي والصراع الفكري والسياسيّ- معنى تحريف القرآن لإثبات ضلالات أخرى. وازداد العداء له مع تنامي الصراعات السياسيّة المرتكزة على تطوّر الفكر الشيعي والاعتزالي والمتصوّف.
رغم ذلك ومع التقدم الحضاريّ وتعدد المرجعيات، ظهرت التأويلات المختلفة بسبب الاختلافات الأيديولوجيّة وتجدد الحركة الفكريّة. فتنازعت الأطراف المختلفة على تحديد مفهوم التأويل. حيث حاول علماء الفقه كبح هذه التأويلات ومصادرتها إلى تأويلٍ واحدٍ صالحٍ لكلّ زمانٍ ومكان. بينما صاغ المعتزلة نظريةً ترى أنّ للفهم مستوياتٍ ومثلها للغموض. وجعلوا المعرفة العقليّة مقياساً للفهم وبالتالي للتفسير. في حين بنى الفكر الحنبلي مذهبه على النقل ومنع الاجتهاد وإرجاع كل المسائل إلى القرآن الذي يفسر بعضه بعضاً، أو إلى الحديث في غياب النص القرآني، ثم أفعال الصحابة. وكان للعوامل السياسيّة والخارجيّة الدور الأبرز في ترسيخ أو اضمحلال تأثير هذه التيارات في الحياة اليوميّة.
التأويل في العصر الحديث
تمّ إقفال باب الاجتهاد بإحكامٍ وتقييد العقل الإسلامي ليتحوّل من التفكير والإنتاج إلى التقليد والتكرار. وأخذ المسلمون لعدة قرونٍ كتب الأقدمين مراجع لهم، وتجنبوا كلام الفلاسفة وأصحاب المنطق العقلي باعتبارهم مضلّلين. ولكنّ الوعي بالهزيمة الفكريّة والعسكريّة وإشكاليّات الاحتكاك بالفكر الأوروبيّ المعاصر دفعت المسلمين إلى استدعاء التراث وخاصّةً الفكر المعتزلي لمواجهة هذه التحديات. فتبنى محمد عبده في منهجه الفكريّ الجامع بين التراث والعلوم العصرية، أنّ هدف التفسير هو تنوير العقل الإسلامي من خلال القرآن. فالقرآن عنده ليس كتاب تاريخٍ، بل هو كتاب هدايةٍ وموعظةٍ للمسلمين ولغيرهم. والله يخاطب البشر على قدر عقولهم لذا فمن الطبيعي أنّ يتطوّر هذا الخطاب بتطوّر العقول.
انقسم المفسرون في العصر الحديث إلى تيّارين مختلفين متصارعين. فبينما تبنّى الأول منهج السلف، واحتكم إلى النقل عنهم والالتزام بتفسيرهم، لتظهر منهم لاحقاً حركة الإخوان المسلمين. اتّبع الآخر، على الرغم من التهديدات والتضييق الممارس ضده، المنهج العقليّ. فقالوا أنّه يجب ألّا نبحث عن الصدق التاريخيّ فيما ورد في القرآن من قصص. حيث أمّنت تلك القصص، التي كانت متداولةً في ذلك العصر، التواصل بين القرآن والنصوص الدينيّة السابقة عليه. فلو كان القرآن جديداً تماماً على العرب حينها لما فهموه ولا آمنوا به. فالجِدّة في القرآن هي جِدّةٌ في الإسلوب والتشريع.
يتخذ الصراع بين منهجي السلف والخلف في التأويل شكلاً دموياً بعد أن كان صراعاً ثقافياً فكرياً. وسيطر أهل السلف الذين هددوا كلّ فكرٍ تجديديٍ على ساحة التفسير. لذلك وجب علينا إيجاد مقاربةٍ جديدةٍ لتأويل القرآن تأويلاً إنسانيّاً معتدلاً لتجاوز حالة الركود الفكريّ التي عانى منها الفكر العربيّ طويلاً.
نظرةٌ جديدةٌ في أفق التأويل
تحوّل النصّ الصامت الذي حُفِظَ في قلوب المسلمين إلى نصٍّ مقروءٍ بعد عمليّة التدوين وإعادة الترتيب والتنقيط، مما أدى إلى تجاهل طبيعته الأصليّة التداوليّة بوصفه خطاباتٍ متعددة المستقبلين التاريخيّن. فالتعامل مع القرآن بوصفه نصاً يقلل من حيويّته ويتجاهل دوره في الحياة اليوميّة. لتجنّب ذلك لابدّ من توظيف أدوات النقد التاريخيّ وعلم الدلالة، المرفوضة في سياق الدراسات القرآنيّة التقليديّة، من أجل قراءةٍ معاصرةٍ للقرآن من خلال النظر في الخطاب القرآنيّ باعتباره عمليّة تواصلٍ ذات خطاباتٍ متنوعةٍ بين الله والنبي.
فمن منظور نصر حامد أبو زيد، يجب التركيز على حيويّة القرآن وتعدد التفاسير في كلّ سياقٍ يتم الاستشهاد به. فكلّ استشهادٍ يتضمّن تفسيراً جديداً. ويجب بالمثل الابتعاد عن تلخيص القرآن حين يتمّ التعامل معه بصفته نصّاً جامداً كما تفعل الحركات الإسلاميّة المعاصرة عندما تحدد سلوك الفرد وحركة المجتمع في قوالب محدّدة. أوقعت هذه القراءة الجامدة المفسّرين في مشكلة التناقض في الآيات القرآنيّة. فاتّبع الفقهاء قاعدة الناسخ والمنسوخ لرفع هذا التناقض. وغاب عن ذهنهم أنّ سياقات القرآن لا يمكن فهمها إلّا وفق منهجٍ تأويليٍ ينظر إلى القرآن بوصفه خطاباً وحواراً. فاختلاف الأحكام ليس تناقضاً وإنّما هو أفقٌ مفتوحٌ أمام المجتمع للاختيار وفق الظروف المتغيّرة.
القرآن بوصفه خطاباً
ينطلق التفسير المفتوح للقرآن في مواجهة التفسيرات الكليانيّة والسلطويّة، من اختلاف الطبيعة الإنسانيّة واختلاف معنى الحياة. فالخطاب القرآنيّ هو عمليّة نقاشٍ ومحاورةٍ تتم وفق متغيرات المتحاورين. والقرآن لا يمثّل خطاباً أحاديّ الصوت، فهو خطابٌ حواريٌ تتعدد الأصوات فيه من صوت المقدّس إلى صوت المَلَك وصوت الإنسان. ويتحول هذا الخطاب إلى سجالٍ مع المشركين يتطور من خلاله الإعجاز البلاغيّ والأسلوبيّ للقرآن من خلال المقارنة بينه وبين الشعر وسجع الكهنة. ويتخذ مع المؤمنين أسلوب الحوار الذي تمّ من خلاله صياغة الأوضاع الفقهيّة.
كتب اخرى للمؤلف
كتب فى نفس التصنيف